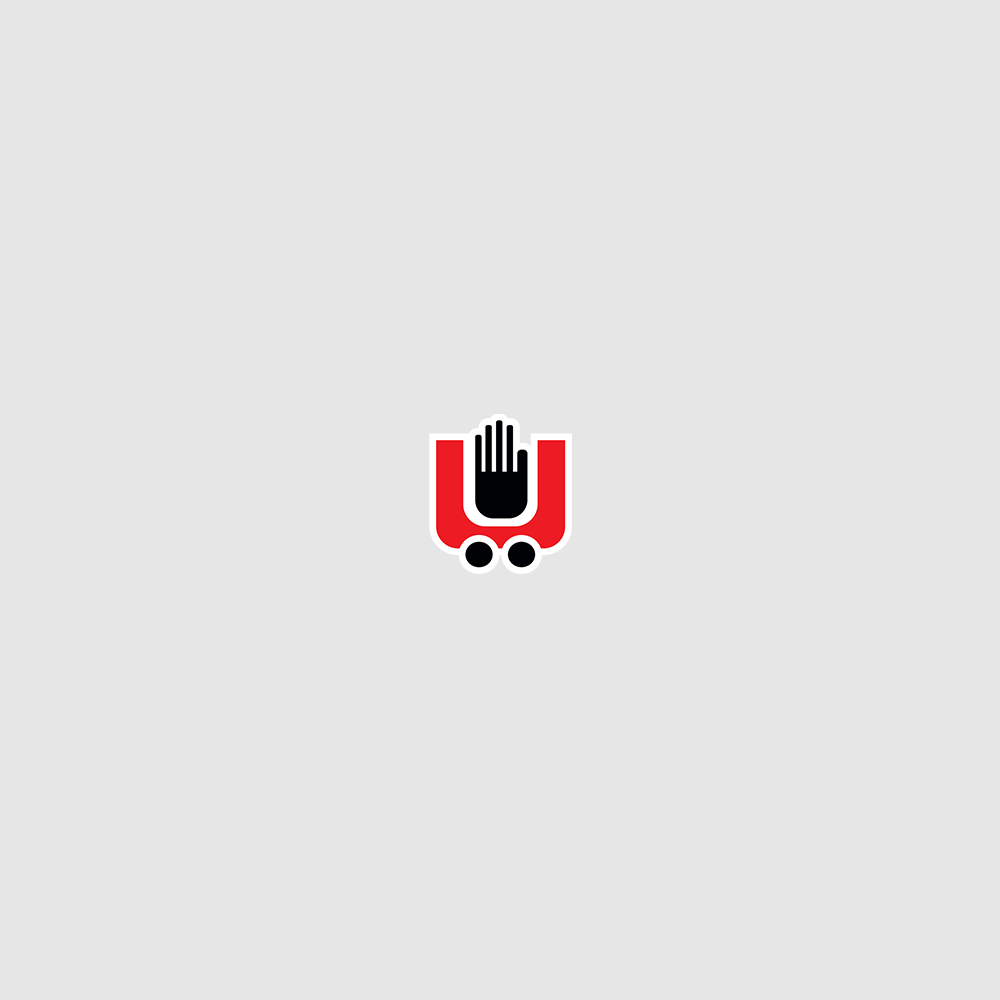من "المسيح" إلى "محمد".. الرحمة أولا.. كانت رسالتهما الأعظم هي: "إنهاض الإنسان وإنارة الطريق"

خمسمائة وسبعون عامًا كاملة فصلتْ بينَ "عيسى" و"مُحمدٍ" –صلى اللهُ عليهما وسلم- ولكن لم تختلفْ الغاية، ولم تتبدلْ القيمة، ولم يضعْ الهدفُ، وهو: " نشرُ السلام". السلامُ الذى كانَ ولا يزالُ الهدفَ الأسمى من اتصال السماء بالأرض، ولكنَّ أكثرَ الناس لا يفقهون. السلامُ..الذي يعبثُ به وفيه الصغارُ والمُدلسونَ والمُرتزقة؛ بحثًا عن مغانمَ رخيصةٍ واتباعًا لأهواء مريضة. الفتنةُ نائمة، لعنَ اللهُ مَن أيقظَها وداومُ على إيقاظها وإشعال نارها.
لم يسعَ "المسيحُ" و"مُحمدٌ"- عليهما السلامُ- من أجل شعائرَ ومناسكَ وعباداتٍ فحسبْ؛ بل كانتْ رسالتُهما الأعظمُ هي: "إنهاضُ الإنسانِ، وإزهارُ الحياةِ، وإنارةُ الطريق للضالين والمُضلين، وإفشاءُ السلام، ونشرُ المحبة، وترسيخُ المودة".
وفيما كانَ "المسيحُ" – عليه السلامُ- يُردِّدُ دائمًا: "لقد جئتُ لأخلِّصَ العالمَ"، "أحبِّوا أعداءكم"، كانَ محمدٌ- صلى اللهُ عليه وسلم- يُخاطبُ أصحابَه قائلًا: "إنَّ اللهَ أرسلني للناس كافةً، وأرسلني رحمةً للعالمينَ ".
الضمير الإنساني
ولأنَّ الضميرَ يُجسِّدُ الإنسانَ فى وجودِه الحقيقىِّ، فقد كافحَ "المسيحُ" كثيرًا؛ لتخليص "الضمير الإنسانىِّ" من وصايةِ الكُهَّان، الذين كانوا يتقاضَونَ الأجورَ لمنح السكينة والطمأنينةِ وإعطاءِ الحُريَّاتِ للناس الأحرار أصلًا، كلُّ شيءٍ بثمنٍ، حتى البركة، فتجمَّدَ الضميرُ لحسابِ أهواءٍ وتقاليدَ وطقوسٍ لا تسمحُ له بمناقشتها ولا باستحسانٍ غيرها؛ حتى لو كانتْ خيرًا منها.. ويرضخُ تحت وصايةٍ غبيةٍ يقيمها حُراسُ هذه التقاليد وسدنتُها، بحسب "خالد محمد خالد" فى كتابه " معًا على الطريق.. محمد والمسيح".
وهكذا عاشَ الضميرُ في كبتٍ قاتلٍ، لا يملكُ حقَّ المعارضة ولا حقَّ التعبير عن نفسه. لم يكنْ الأمرُ يختلفُ كثيرًا في "مكة" وباقي الأرض قبلَ بعثة الرسول - محمد صلى الله عليه وسلم- الذى أعادَ إلى الضمير الغائب "هيبتَه المفقودة"، و"وقارَه المسلوبَ"، وسطَ عالمٍ لم يكنْ يؤمنُ إلا بالقوَّةِ والجبروتِ والغطرسةِ، بل إنَّ الأعظمَ من ذلك كله هو أن الإسلامَ لا يعرفُ مصطلحَ "رجال الدين" ولا يُقرُّه، إنما هم علماءُ ناصحونَ، لا وصايةَ لهم على البشر من قريبٍ أو بعيدٍ.
وكما كانتْ الرحمة عُنوانًا لـ "المسيح" – عليه السلامُ- فإنها كانتْ أيضًا مِنهاجًا لـ "محمدٍ" – صلى اللهُ عليه وسلَّمَ- لم يَحِدْ عنها يومًا، مهما اشتدتْ الظروفُ وتعاقبتْ الأهوالُ وتعاظمتْ البلايا. فها هو "عيسى" يخاطبُ أولئكَ الغاضبينَ المُتأهبينَ لرجم امرأة خاطئة: "مَن كان منكم بلا خطيئةٍ فليرمْها بحجر"، ليسَ استباحةً لاقترافِ الآثام والخطايا والدنايا.
ولكن تأكيدًا على أنَّ الخطيئة نفسَها جزءٌ من الأغلال التي يرسِفُ فيها وجودُنا، وعلينا ونحنُ نحرِّرُها أنْ نفطمَها عن نزواتِها. تمامًا كما وبَّخَ "مُحمدٌ" مَنْ استأذنه لطرد شخصٍ يعتقدُ أنه منافقٌ يتظاهرُ بالإسلام ليؤذي المسلمين، ويُخفي في نفسِه شرًا ويُضمرُ في دواخله أذىً ؛ فيسألُ "مُحمدٌ" صاحبَه: "هلا شققتَ عن قلبِه؟!"، قبلَ أنْ يستطردَ ناصحًا وواعظًا ومعلمًا وهاديًا ومرشدًا: "إنَّ اللهَ لم يأمرْني أنْ أشُقَّ صدورَ الناسِ لأرى ما فيها"!
لم يكتفِ نبىُّ الإسلامِ بذلك، بل يُقسمُ بربه تعالى:"والذي نفسي بيدِه.. لو لم تُذنبوا لذهبَ اللهُ بكم، ولجاءَ بآخرينَ يذنبونَ فيستغفرونَ فيُغفَرُ لهم"، فـ"كلُّ ابن آدم خطّاءُ، وخيرُ الخطاءين التوَّابون"، ثم يؤكد وصاياهُ النصُّ القرآنىُّ الخالدُ: "ومَن يعملْ سوءًا أو يظلمْ نفسَه ثم يستغفرْ اللهَ يجدْ اللهَ غفورًا رحيمًا".
الإنسان أولًا
جاءَ "المسيحُ" و"مُحمدٌ"، ومِن قبلهما الأنبياءُ أجمعون؛ عليهم جميعًا من اللهِ السلامُ، من أجل إصلاح الإنسان؛ لأنَّ الإنسانَ هو حجرُ الزاوية فى هذه الدنيا، لا صلاحَ يمكن أن يتحققَ على الأرضِ من غير إصلاحِه أولًا؛ فالنجاحُ يحققُه إنسانٌ، والفشلُ يصنعُه إنسانٌ. الانضباطُ يحققُه إنسانٌ، والفوضى يصنعُها إنسانٌ. الخيرُ يحققُه إنسانٌ، والشرُّ يصنعُه إنسانٌ. الفضيلةُ يَحميها إنسانٌ، والرذيلة فِعلٌ أيضًا إنسانىٌّ بامتياز.
العلمُ يكتشفُه ويُطوِّرُه إنسانٌ، والجهلُ يحتضنُه إنسانٌ. الدولُ القوية يسكنُها إنسانٌ، والدولُ المُتدنية يقطنُها إنسانٌ أيضًا. العنصرُ الإنسانىُّ، الذى جاهد "المسيحُ" و"محمدٌ" – عليهما السلامُ- فى سبيل إصلاحِه والارتقاءِ به، هو حجرُ الزاويةِ في كلِّ شئٍ: بناءِ الحضاراتِ وهدمِها، تقويةِ الدول وكسرِها، إقامةِ المدن الفاضلةِ أو تحويلِها إلى مُدن أشباح. الإنسانُ هو الإنسانُ، سواءٌ خرجَ إلى دنياهُ في إحدى دول العالم الأول، أو في دولِ “الترسو”.
لكنَّ الأجواءَ التي ينشأ ويشبُّ ويعيشُ فيها هي التي تجعلُ منه إنسانًا صالحًا كما أراد "محمد" أو طالحًا كما خططَ الشيطانُ، مُنضبطًا كما أرادَ "المسيحُ"، أو فوضويًا كما أرادَ "إبليسُ". الدولُ التي تُربِّي أبناءَها على القيم المثالية التى أوحتْ السماءُ بها إلى الأرض، وناضلَ من أجل نشرها "المسيحُ" و"محمدٌ" –عليهما السلامُ- تجني من ورائِهم خيرًا، والدولُ التي تُربيهم على السلوكيات الشيطانية، وتُقصِّر فى إرشادهم، وتستهينُ بأوامر السماء، لا تحصدُ منْ ورائِهم إلا شرًا. لنْ ينصلحَ حالُ الوطن، "أي وطن"، دونَ تربيةِ أبنائه مِنْ الصِّغَر على قيمِ: الحُب والخير والجمال والعدل. وهى القيمُ ذاتُها التى سعى فى سبيل نشرها وترسيخها كلٌّ من: "المسيح" و"محمد"، عليهما السلامُ. الأشرارُ لا يبنونَ أوطانًا، ولا تحمي السماءُ أوطانَ الظلم والكراهية والقُبح والفوضى والعنف والإرهاب والتطرف والانحلال والانحراف.
نقلًا عن العدد الورقي…