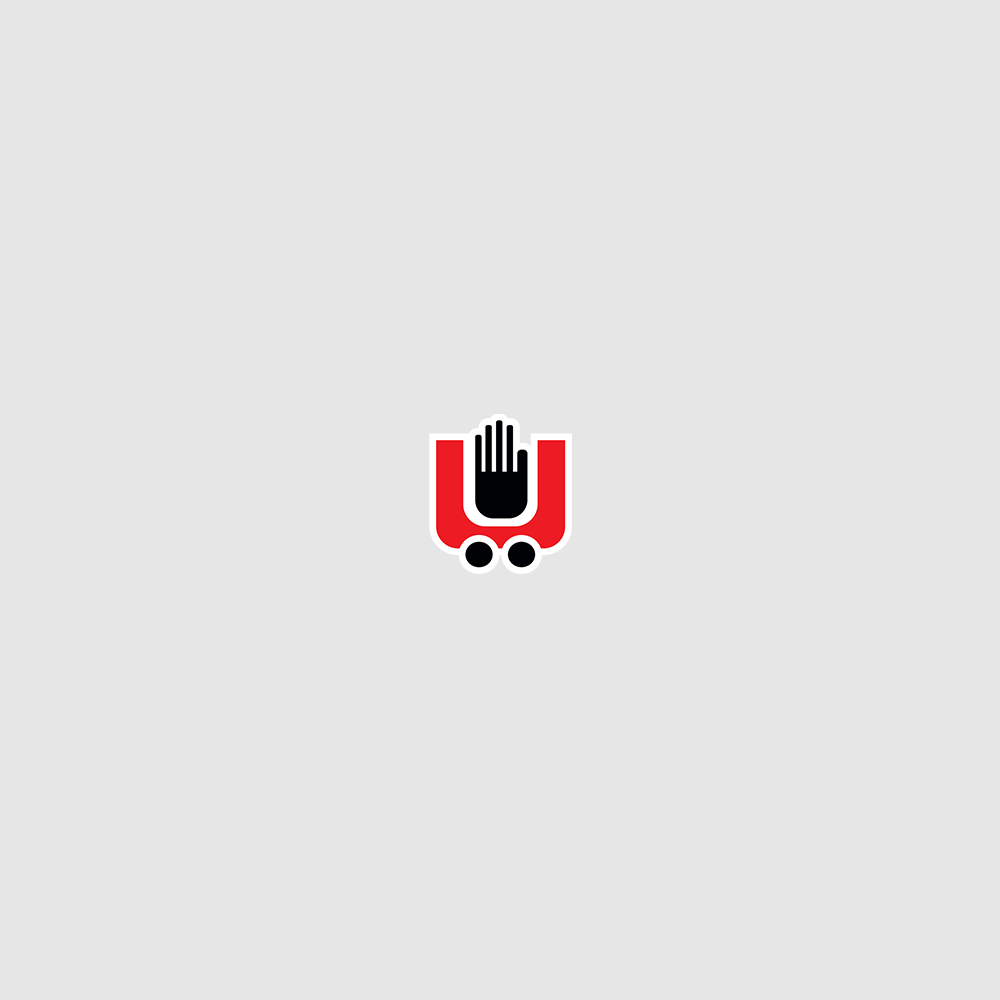الفساد ثقافة مصرية
يفرح البعض بالإعلان عن ضبط موظف كبير وهو يتقاضى رشوة مالية، ويصف بعض المسئولين ذلك بمكافحة الفساد، والحقيقة أن الفساد في مصر أكبر من ذلك بكثير، وأن من يتسلمون أموالا أو هدايا عينية بأنفسهم مقابل تقديم الخدمات هم أبسط أنواع الفساد.
بل أن كبار الفاسدين من المرتشين ومنذ سنوات طويلة، الكل يعلم أنه يتم إيداع مبالغ الرشوة التي طلبوها في حسابات خاصة ببنوك أجنبية وبأساليب معروفة منذ زمن بعيد، والحقيقة أن الفساد المالي في مصر هو نقطة في بحر الفساد المجتمعي، حتى مع كل مظاهر الفساد المالي من أبسط صورها العشرة جنيهات، التي تلقى في درج موظف وحتى عشرات ومئات الملايين من الدولارات التي تودع في حسابات في بنوك سويسرا والكاريبي وجزر الباهاما.
ثم يأتي الفساد الإداري وهو تمكين النفس أو الغير بطريقة غير قانونية، أو بالتحايل على القانون من التربح المؤقت أو الدائم وبطريقة قانونية.. أكثر صور هذا الفساد هو الفساد في التعيينات، والشراء بالأمر المباشر، وترسية المناقصات بالأمر المباشر، والتمييز الإيجابي لأبناء العاملين أو المرأة، والتمييز السلبي لأي سبب آخر.
الفساد في مصر يمارسه كل مواطن كل يوم في حياته، بدء من عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والواجبات، حتى أصبح ذلك ثقافة نمارسها جميعا دون أن نشعر.
في البيت.. من منا من لم يستمع أو يشاهد فيلما أو أغنية أو يقرأ كتابا منسوخا دون حقوق ملكية، وفي الشارع.. أصبح الالتزام بقوانين وقواعد المرور حتى لمن رغب أشبه بالقبض على جمرة من نار، فالكل من حولك لن يسمحوا لك أن تلتزم بسرعة مقررة أو مكان انتظار أو احترام إشارة صفراء، أو اتجاه السير في شارع مزدحم، أو حتى احترام أماكن عبور المشاة خاصة على الطرق السريعة.
ورغم أننا ندفع ثمن الفساد على الطرق أكثر من عشرة آلاف قتيل سنويا، ثلثهم من الأطفال، فإن المجتمع لم يعد حساسا لذلك، وتوقف الكلام عن بحث أسباب الظاهرة أو التعامل معها، إلا في مناسبات وقوع الحوادث الكبرى.
أتذكر كل ذلك مع الحملة التي حاول البعض تنظيمها لإيقاف عجلة الإصلاح في النظام الصحي الجامعي، ورغم صدور تنظيم المستشفيات الجامعية في أبريل الماضي، أي منذ نحو ثمانية أشهر بعد فترة مخاض صعب تعدت العشر سنوات، تباينت فيها الأفكار والرؤى بشدة، وكتبت فيها مسودات للقانون تختلف عن بعضها البعض جملة وتفصيلا، وقفنا ضدها جميعا وحددنا إطارا وقواعد لما يمكن أن نوافق عليه.
أهمها عدم عمل الأطباء في المستشفيات بالسخرة دون أجر عادل، ومشاركة المستشفيات في المسئولية الطبية، وقيامها بالتأمين الكامل على العاملين لديها، وعدم اعتبار الثروة البشرية المميزه الموجودة في المستشفيات عبئا ولكن قيمة مضافة يجب الاستفادة منها لأكبر قدر ممكن، ثم ضمان تمويل يكفي لحل مشكلات المستهلكات والصيانة والأجور والتطوير، وأخيرا الإصلاح الإداري حتى وصلنا إلى الصيغة الحالية من القانون، والتي تمنح الفرصة لتحقيق كل ذلك.
وأقول تمنح الفرصة لأن القوانين لا تغير، وإنما هي الإرادة المجتمعية التي تستغل القوانين الجيدة في التغيير، وكم من قوانين جيدة صدرت منذ سنين، وما زالت في حياتنا مجرد حبرا على ورق.
بدأ الهجوم بكلام ليس له أي علاقة بالقانون واتهامات معلبة، فمن قال أنه قانون لبيع وخصخصة المستشفيات وهى تعبيرات محفوظة ومتكررة تصدر في كل المناسبات من الزملاء في تيار اليسار، وكأنهم يستخدمونها كوقاية من أي احتمالات للخصخصة، لكن استخدامها بتكرار وفى غير موضعها أصاب المواطنين بالملل، وشكك في جديتها، حتى أني أخشى أن حدثت يوما محاولات للتخلص من أملاك عامة، لن يصدقنا الناس حينها من كثرة ما سمعوا تلك الاتهامات والشعارات دون مناسبة.
ثم سمعنا كلاما عن التخلص من أعضاء هيئة التدريس، رغم أن أن القانون في الحقيقة يلزمهم جميعا ولأول مرة بالعمل في المستشفيات الجامعية ومقابل أجر، وأن القائمين على كتابة اللائحة كانوا حريصين، أن تكون هناك خيارات متعددة تتناسب مع رغبات الأساتذة في العمل والالتزام، بل جعل من يحضر يوما واحدا في الأسبوع نوعا من الالتزام، وأن لا يتسبب القانون في وقوع أي ضرر لأي أستاذ.
لكن ثقافة عدم الرغبة في الالتزام ولو بالحد الأدنى، جعلت البعض يحاولون تشويه هذه المحاولة للإصلاح، لكن التغيير سنة الحياة، حتى وصلنا إلى أسوأ وضع ممكن غير قابل للاستمرار، يعاني فيه المواطن والمريض والطبيب وغالبية أعضاء هييئة التدريس في كليات الطب.
وتذكرت ما حدث منذ أكثر من عامين، عندما ذهبت إلى رئيس هيئة التأمين الصحي بمشروع مركز نموذجي لجراحة، قلب الأطفال في مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، بأفكار مستوحاة من تجربة الدكتور محمد غنيم القائمة على التفرغ للعمل في مكان واحد، لضمان أفضل خدمة طبية للمريض، ومنع تضارب المصالح والتشتيت للطبيب.
كانت الخطة بسيطة ولا تعتمد على تمويل مالي إضافي، وإنما زيادة حجم العمل لكل جراح عن طريق زيادة حجم العمل بنفس أسعار التأمين الصحي، وضمان تواجد الأطباء أربعة أيام على الأقل بالمركز، وتناوبهم في رعاية المرضى، وفتح غرفة عمليات إضافية.. وشجعني على ذلك وجود مدير كفء متعاون وصاحب رؤية، ووافق ٤ جراحين على التفرغ التام للمركز، وعمل ٦ عمليات أسبوعيا وعيادات.. إلخ.
المفاجأة كانت في المعارضة الشديدة لزملاء آخرين لا يعملون في المركز، وتحايلهم بكل طريقة لمنع تطبيق ذلك لأسباب مختلفة.. منهم من يريد أن يظل اسمه موجودا رغم أنه لم يجر جراحة واحدة خلال ٣ سنوات بالمركز، ومنهم من لا يعمل نهائيا بالمركز، ولكن يخشى نجاح الفكرة فتهدد سيطرته وحده على ٣ مراكز رغم تضارب المصالح فيها.
ومنهم من يرفض عمل مركز نموذجي، ويريد أن يشترك بحالة أو حالتين أسبوعيا، حتى إذا كان النظام لا يسمح للطبيب بمتابعة أي مريض، ومنهم... ومنهم... كانت تجربة أوضحت لي مدى الفساد الذي وصلنا إليه، وهو فساد مجتمعي، وثقافة عامة مفادها أن أفضل الطرق هي أقلها جهدا، وأن العائد مقدم على أي شيء، وأن المصلحة الشخصية مقدسة، حتى لو كانت بتدمير أي نظام أفضل.
تذكرت ذلك كله مع مناقشات قانون المستشفيات الجامعية، ومحاولات حماية النظام الفاسد، الذي لا مثيل له في الدنيا.