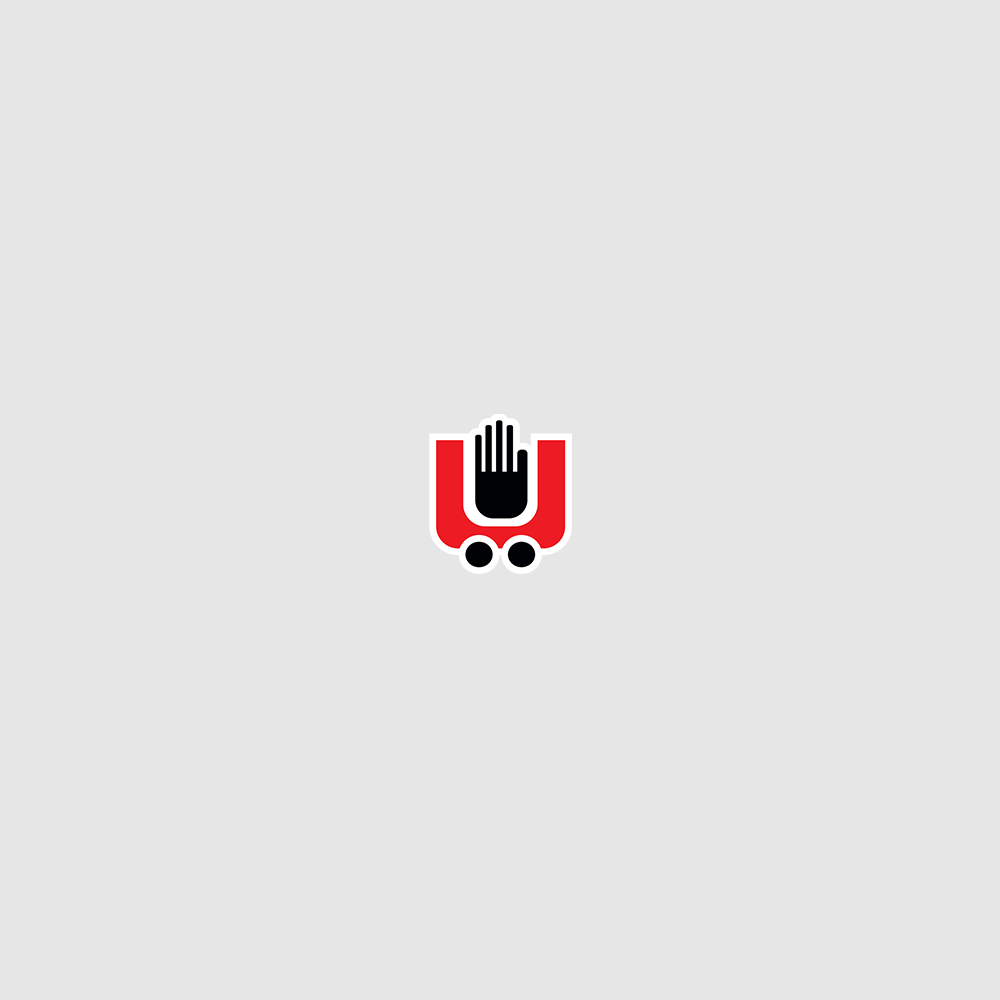كفاياك يا ولدى
كان صوتها هذه المرة حزينا .. لم تسألنى ـ كعادتها ـ عن أحوالى .. ولم تبد أى اهتمام بمعرفة آخر استعداداتى لاتمام الزواج ، ولم تردد على مسامعى مقولتها الشهيرة التى صرت أحفظها عن ظهر قلب "عايزة أفرح بيك ياولدى نفسى أشوف ولادك قبل ما أموت" ، ولم تمارس طقوسها المعتادة فى إخبارى بأحوال الأهل والعشيرة فى تلك القرية الصغيرة من صعيد مصر.
للحظات تخيلت أن أحدا من أفراد العائلة قد انتقل إلى رحاب ربه وإنها تتصل لتبلغنى بالخبر حتى أكون فى مقدمة مشيعى الجنازة.. حاولت أن أهدأ من روعها ومازحتها قائلا : "مين اللى مات المرة دى؟" .. ردت فى حزم : "كفاياك يا ولدى سيبك من القاهرة وناسها وتعال عيش وسطينا" قلت لها :"ليه إيه اللى حصل؟" .. أجابت بعفوية : "والنبى يا ولدى ما نمت من عشية من ساعة ما عرفت ان الناس الوحشة بيهجموا على الصحفيين وبيحرقوا مقرات الصحف وانت عارف أنا ماليش غيرك فى الدنيا".
بعد مكالمة طويلة نجحت فى إقناع أمى ـ التى قضت أجمل سنين عمرها فى تربيتى ــ أننى بخير ولم يصبنى أى مكروه، وأننى فقط أعانى حالة اكتئاب مثلى مثل عموم المصريين الذين لا يجدون أى بارقة أمل فى مستقبل أفضل، ورغم أن أمى فلاحة بسيطة لم تنل أى قسط من التعليم ولا تشاهد برامج "التوك شو" المسائية ولا تستمع إلى ثرثرة النخبة أو شطحات تجار الدين إلا أنها بعاطفة الأمومة أحست بوجود خطر على حياتى بعد أن تحول الصحفيون إلى هدف لمن يعتقدون أنهم يملكون صكوك الغفران ويعتبرون من يختلف معهم مارقا خارجا على الدين.
أنهيت المكالمة وعدت لاستكمال عملى لكن كلام أمى أصابنى بقشعريرة لم أشعر بها من قبل وأفقدنى أى قدرة على متابعة ما يجرى من أحداث متلاحقة .. ووجدتنى دون أن أدرى أتذكر وجه والدة زميلنا الحسينى أبوضيف شهيد الصحافة وصرخاتها التى لم تتوقف منذ إعلان وفاته وحتى الآن ، وقلت فى نفسى ماذا لو كنت أنا مكان "الحسينى" .. هل كانت أمى ستغفر لى؟ وهل ستصدق أنى مت فى سبيل الوطن ؟ وهل التعازى الحارة ومنحها لقب "أم الشهيد" سيعوضانها فقدان ضناها؟ .. سامحينى يا أمى.