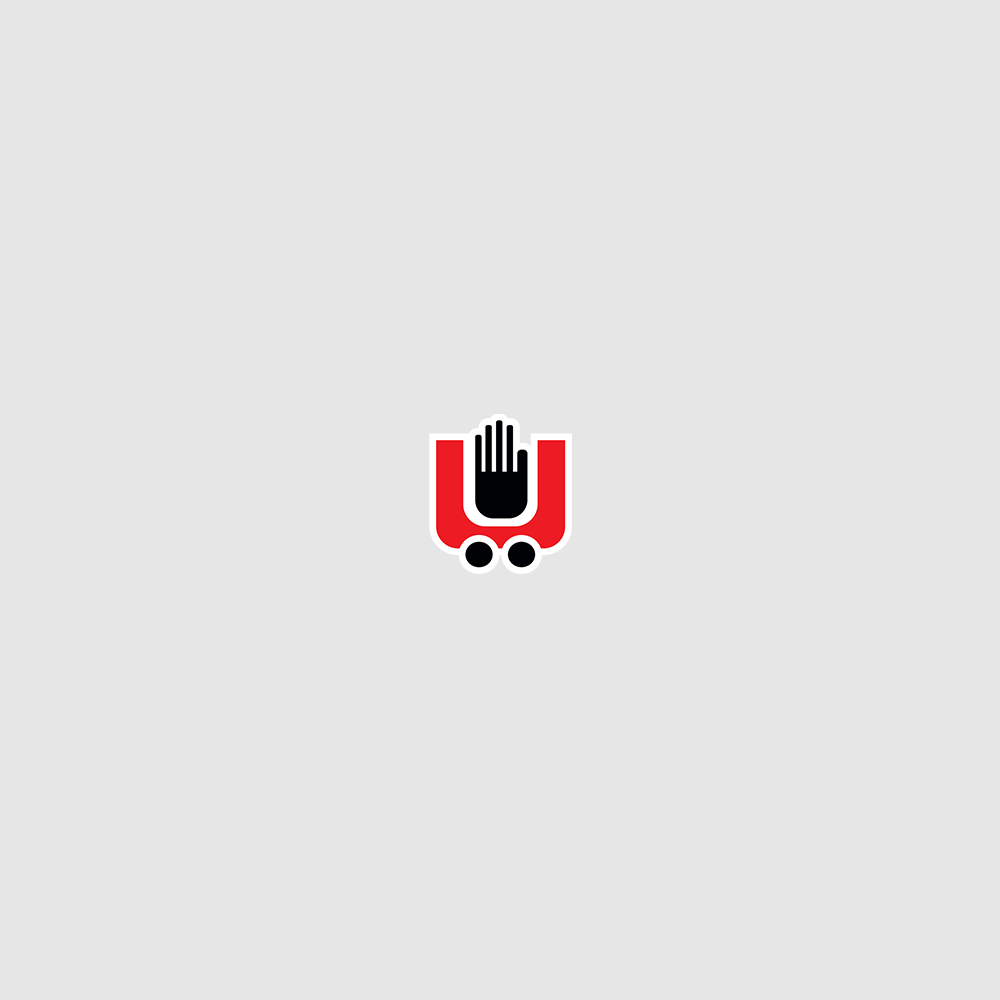الإصلاح والإفساد
سمعنا في الأعوام القليلة الماضية كلاما معسولا حول الإصلاح الاقتصادى، ووعودا جوفاء غير منطقية من مسئولين كبار حول حل مشكلة الدولار في ثلاثة أشهر والوصول إلى سعر صرف الدولار إلى أربعة جنيهات، والوصول بدخل قناة السويس إلى عشرين مليارا من الدولارات في العام الواحد خلال عشر سنوات، والتأمين الصحى الشامل، وتخفيض أسعار الأدوية، والمستهلكات إلى غير ذلك مما سمعناه جميعا غير أننا صدمنا بحدوث عكس ذلك تماما على الأرض.
وإذا نظرنا إلى أرض الواقع بنظرة تحليلية موضوعية بعيدا عن التجاذبات السياسية، والأيديولوجية لوجدنا الوضع على الأرض في تباين كبير فالتضخم في مصر وصل إلى معدل غير مسبوق في تاريخها الذي يمتد إلى آلاف السنين (المعدل الإجمالى لزيادة أسعار السلع، والخدمات خلال فترة زمنية محددة)، وهو الذي تعلن الحكومة نسبا له في حدود 25% بينما ما نراه واقعيا يصل إلى أكثر من 100% في بعض التقديرات في ظل هبوط سعر صرف الجنيه بنسبة تصل إلى 70%، ومضاعفة سعر الفائدة على الودائع، والإقراض، وتسمع من المسئولين كلاما عن الإصلاح الاقتصادى، والقرارات الجريئة الشجاعة، وما إلى ذلك من التسويق الإعلامي للسياسة الاقتصادية، والنقدية الحالية إن وجدت !
وإذا بحثنا عن الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية لوجدناها تعود إلى عاملين رئيسيين، أولا: عدم الاستقرار السياسي وما يرتبط به من اضطرابات أمنية أدت إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية، فضلا عن إلحاق الضرر بقطاع السياحة، الذي يسهم بـ12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خاصة بعد قيام منتدى الاقتصاد العالمي بتصنيف مصر كإحدى أخطر المناطق للسياحة في 2012، وعدم الخروج من هذا النفق المظلم حتى الآن رغم التحسن الأمني الكبير إلا أن تضخيم بعض الحوادث الإرهابية حال دون ذلك..
فيما يتمثل العامل الثاني في عدم مرونة السياسات المالية والنقدية، خاصة ما يتعلق بتصاعد عجز الموازنة نتيجة لسياسات الدعم، وجهود مواجهة انخفاض قيمة العملة، فترى العديد من التحليلات الاقتصادية أن سياسات الدعم التي تفتقد الكفاءة والفاعلية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة هي أحد أبرز العناصر الضاغطة على الاقتصاد المصري، إذ تستحوذ فاتورة الدعم على ثلث الميزانية الحكومية بقيمة 20 مليار دولار، ناهيك عن عدم وصوله إلى مستحقيه، واستفادة الفئات غير المستحقة للدعم منه.
ومن ثم، يكون الإصلاح الاقتصادي والخروج من هذه الأزمة الاقتصادية غير ممكن إلا من خلال سياسات تعالج هذين الجانبين، أي تعمل على تحقيق الاستقرار السياسي، وضمان توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين الأجانب من جهة، وإعادة النظر في سياسات الدعم والعمل على إصلاحها من جهة آخر.
الوجه الآخر من العملة، وهو الأكثر قتامة فهو انعكاس الأحوال الاقتصادية على معيشة المواطن، وخاصة في ظل التركيبة الغريبة التي وصلنا إليها، ووصول الفساد إلى أخطر المجالات كالتعليم، والصحة مما خلق أجيالا اختلط عليها توصيف الفساد، وأصبحت المصالح الشخصية، والفئوية هي الغالبة حتى لو أدت إلى تدمير المجتمع، الشعب المصرى يعانى من الارتفاع الشديد في معدلات الاستهلاك، والانخفاض الشديد في معدلات الإنتاجية، وتضاؤل نسبة العاملين إلى قوة العمل الأساسية (القادرين على العمل بين سن 16، و60 عاما)، وترسخ ثقافات الاهتمام بالألقاب، واحتقار العمل الحقيقى، والاهتمام بالمظاهر، وانعدام العدالة في تقييم العمل، ومردوده.
لكن الخطر الأكبر على مصر اتضح أنه من انعدام وجود سياسة حقيقية للإصلاح السياسي، والاقتصادى فمن الناحية السياسية تستمر السلطة في الاعتماد على تزكية سياسة الاستقطاب، ونشر الكراهية، والتمكين للولاء، وأهل الثقة بدلا من محاولة رأب الصدع الوطنى، والوصول إلى حالة من الوفاق الوطنى توحد الشعب حول المصالح الوطنية تماما كما فعل مانديلا في جنوب أفريقيا بعد إنهاء سياسة الأبرتيد، ودون ذلك، ومع استمرار سياسة التخويف، وتضخيم الحوادث الإرهابية فلن يكون هناك أمل في عودة السياحة أو توحد الشعب خلف القيادة السياسية التي تكتفى حتى الآن بمناصريها في استمرار واضح لسياسة الأهل، والعشيرة التي مزقت مصر سياسيا.
ومن الناحية الاقتصادية فحتى الآن لا توجد خطة حقيقية للإصلاح الاقتصادى تستهدف حل جذور المشكلة مع ضمان الحد الأدنى للمعيشة الآدمية للمواطن المصرى الصالح الذي يشارك بكل جهده في التنمية المجتمعية، والأخطر من ذلك استمرار الرشاوى السياسية فتارة الوعد باستمرار الدعم لغير مستحقيه سواء من القادرين أو من الرافضين للعمل، واستمرار إهمال وضع نظم لرصد الاستحقاق الحقيقى للدعم يكون المشاركة في التنمية عن طريق العمل هي السبيل الوحيد لاستحقاق الدعم النقدى الذي يكفل الحد الأدنى من الحياة الآدمية مع ربط ذلك مع سياسات واضحة للحد من الزيادة السكانية، وتوفير خدمات حقيقية في التعليم، والصحة، وغيرها من الخدمات.
وحتى الآن تستمر سياسة المشروعات الدعائية البعيدة كل البعد عن حل المشكلة الاقتصادية كدعم الإسكان لعدد من المواطنين على حساب باقى الشعب، وعلى حساب تدمير اقتصاد التشييد، والبناء ككل، والاستمرار في الإنفاق على العاصمة الإدارية رغم الأزمة الخانقة، والعديد من الأنفاق تحت القناة دون أي اهتمام بالجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع، وتوقيتها في ظل الأزمة الاقتصاية الطاحنة، وفى تكرار واضح لمشروع قناة السويس الجديدة الذي استهلك أكثر من مائة مليار جنيه، وأنه كان من الأولى استثمار تلك الأموال في الاستثمار الصناعى، والتجارى، والسياحى في تنمية محور القناة بدلا من الحفر.
واتخذت الحكومة القرار الأسهل، وهو الاستدانة بدلا من مواجهة المشكلة بسياسات واضحة تطبق بعدالة على الجميع لحل الأزمة، وزاد الأمر سوءا بزيادة الضرائب ثم تخفيض سعر العملة دون تحرير الصرف فحتى الآن الحكومة تشتري العملة الصعبة، ولا تبيعها مما ساهم في مزيد من الانهيار في قيمة العملة وتزامن ذلك كله مع رفع الدعم، وكأن الحكومة اختارت التخلص من كل أعبائها النقدية بكل الطرق دون وجود أي خطة أو إستراتيجية لحل الأزمة، وتقليل مخاطر الامتداد السريعة للأزمتين السياسية والاقتصادية إلى أزمة اجتماعية طاحنة يؤدي الفقر فيها إلى فوضى عارمة قد لا نستطيع السيطرة عليها، وتمنح الفرصة لكل متربص بهذا الوطن أن يكيد له مستغلا الأخطاء الفادحة للإدارة.