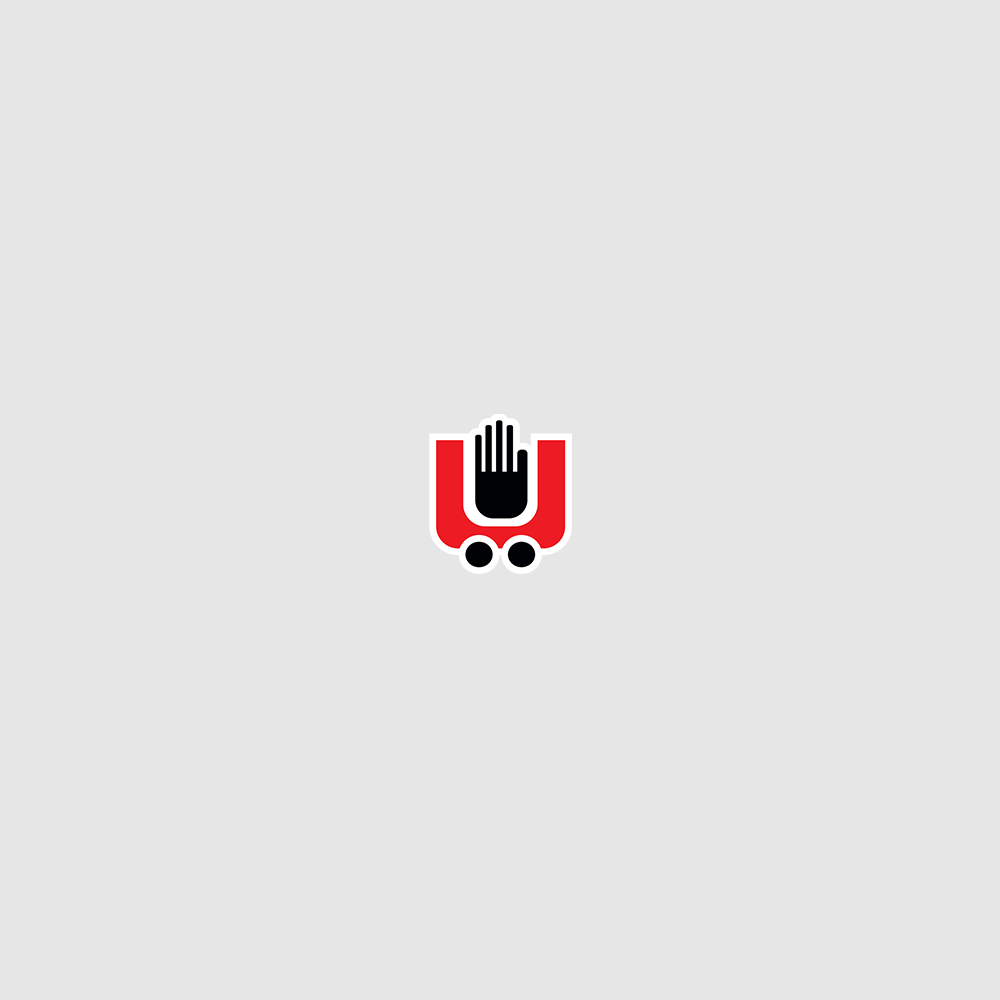مريض على سرير النساء!
في المساء، قاومتُ المرض بنسيانه حتى غفوت.. إلا أن الألم في الصباح كان أقوى من كيد النساء.. فطلبتُ من زوجتي الغوث.. ولأنني لا أتذكر الطبيب إلا في اللحظات الحرجة، فقد استشعرت زوجتي الخطورة.. فتركنا الأولاد في شقة المصيف؛ قاصدين أقرب مستشفى يقدم رعاية طبية متميزة.
بعض أهالي الإسكندرية أرشدونا إلى مستشفى «أبو هندية».. وقد كان.
قذفتُ بنفسي داخل السيارة؛ متخذًا من الكرسي الأمامي سريرًا، بينما كانت زوجتي تتابعني من المقعد الخلفي، كما يتابع المخبرون خط سير المطلوبين أمنيًا..
طوال الطريق، الذي لم يستغرق سوى بضع دقائق، كنت أتلوى من الألم.. صراخي يتفوق على ضجيج المصطافين، كما تفوق «ساس» الإسرائيلي على لاعب الجودو المصري «إسلام الشهابي».. نظرات زوجتي كانت تلخص المشهد دون أن تنبس ببنت شفة.
أخيرًا وصلنا إلى المستشفى «الخاااص جدًا».. المبنى من الخارج «فخم»، ويبعث على الاطمئنان.. لكن بمجرد دخولي إلى الاستقبال تأكدت أن كل ما يلمع ليس بالضرورة أن يكون ذهبًا.
حالتي الصحية كانت واضحة وضوح «أقلام» المخبرين على أقفية المتهمين.. إحدى الممرضات تعاطفت مع حالتي، وطلبت من زوجتي الدخول بسرعة إلى غرفة الطوارئ لتوقيع الكشف الطبي، على أن نقطع تذكرة الدخول فور انتهاء الكشف.
الحمد لله.. رددتها في سري، ظنًا مني أن الأحوال في مصر تغيرت إلى الأفضل، وأن المريض يحصل على الخدمة الطبية أولًا، ثم يأتي «الحساب» بعد ذلك.
دخلنا غرفة الطوارئ.. حجرة فقيرة للغاية، وضيقة أكثر من ضيق حاكم مستبد من انتقادات معارضيه.. مساحتها لا تسمح لذوي الطول من أمثالي أن يفرد ذراعيه، حتى لا يصطدم بالحائط.. الطبيب -عرفنا فيما بعد أن اسمه أحمد- على الأرجح أنه طبيب امتياز، أو حديث التخرج.. وكان يجلس إلى مكتب متواضع، ومنهمكًا في اللعب على «التاب»!
ماله، فيه إيه؟ قالها الطبيب، دون أن يرفع نظره من على «التاب».. فأجبته ساخرًا: «خلَّصْ الجيم الأول يا دكتور.. ربنا معاك.. وسيبك منِّي!».. توقعتُ أن «يتنحرر» من تهكمي عليه، لكنه فاجأني برد فعل أبرد من القطب الجنوبي.. لم يرفع عينيه من على شاشة «التاب».. وهنا احتدتْ زوجتي عليه:
- ماله إيه.. تعبان.
- أيوه يعني بيشتكي من إيه؟
- بطنه بتتقطع زي ما إنت شايف.
- أيوه ودا من إيه بالظبط؟
- مش عارفة والله!
- يمكن يكون أكل حاجة مش نضيفة، أو شرب مية بحر، أو..
بلهجة ساخرة وحادة، قاطعته زوجتي: وجايز لما تقوم وتكشف عليه تتضح حاجة تانية..؟!
هنا لم أحتمل الوقوف على قدمي، فألقيت بنفسي على سرير الكشف، فقام الطبيب «الشاب» على مهل، ووضع السماعة في أذنيه، وراح يضع طرفها الآخر على بطني وصدري بطريقة روتينية، طالبًا مني التنفس، فنفذت ما أراد.. وبعدها أحضر جهاز قياس الضغط، وما أن انتهى طلب من الممرضة تركيب بعض المحاليل وبها بعض الحقن.
"ممكن يكون تلبك معوي حاد، أو يمكن يكون ميكروب في المعدة، أو جايز شوية التهابات في المعدة.. المهم يا.... خد المحاليل دي الأول، وبعدها نعمل شوية تحاليل، ومنظار".. هكذا رد الطبيب على زوجتي عندما استفسرت منه عن سبب الألم.
لم تكن هناك غرفة خاوية.. فكل الغرف يقطنها المرضى..
حالتي كانت تسوء بمرور الوقت، والممرضات يجتهدن في توفير مكان يسمح براحتي وتركيب المحاليل.. وأخيرًا استقر الأمر على غرفة بجوار الاستقبال.. وعرفت- فيما بعد أنها الحجرة المخصصة للكشف على النساء!
الغرفة تبدو وكأنها إحدى مخصصات قسم الـ«it»، أو «السويتش».. فالأسلاك الخارجة من الحوائط تبدو كالأفاعي في موسم التزاوج.. كيس بلاستيك أصفر اللون ممتلئ بالخبز البلدي قابع على مكتب خشبي رديء، مُغطى بمفرش بلاستيكي امتدت إليه يد الإهمال والقذارة.. أرضية الحجرة كانت بحاجة إلى هيئة النظافة، وشركة «ديتول» ليتم تطهيرها.. و«التكييف» بدا وكأنه من مخلفات الحرب العالمية الأولى.
لم يكن أمامي خيار سوى الرضوخ.. والنوم على السرير، المتسخ، المتهالك في هذه الغرفة، بعد أن طلبتُ منهم «مُلَاءَة» نظيفة أواري بها سوءة السرير.. بقيتُ أكثر من خمس دقائق مستلقيًا على السرير؛ منتظرًا «الملاءة»، وبحث العاملة عن «حامل» معدني لتركيب المحاليل..
أخيرًا، وجدوا «الحامل» الذي بدا وكأنه يعاني مرضًا هو الآخر.. فقد كان في حالة يرثى لها.. فالصدأ تمكن منه، من قاعدته إلى قمته..
استسلمت للأمر الواقع؛ مرددًا في نفسي: «هي دي مصر يا عبلة»..
جاءني صوت ممرضة لم أتبين ملامحها جيدًا: «افتح إيد واقفلها تلت أربع مرات».. انعقد حاجباي من الدهشة.. فعروقي تبدو واضحة وضوح بطن الحامل في شهرها التاسع.. لكن في النهاية نفَّذتُ ما طلبته مني.
طريقة الممرضة في غرس سن إبرة «الكانيولا» في ذراعي، بدتْ كـ«كفيف» يقود سيارة؛ محاولًا الوصول إلى مبتغاه.. هنا استشعرتُ الخطورة.. فأنا أرتضي الوفاة بالمرض، لكن بالإهمال لا وألف لا!
طلبتُ من زوجتي الاتصال بزميلي خالد الأمير- مراسل الجريدة بالإسكندرية- للاستعانة به في معركتنا العلاجية، والبحث عن مستشفى آخر يحترم حق المريض في العلاج.
بعد نحو ثلث ساعة حضر «خالد».. كنتُ مستسلمًا لخرطوم المحاليل وهو يتولى نقل السوائل، والمسكنات إلى جسدي..
بمجرد حضور «خالد» المعاملة تغيرت.. عرفتُ فيما بعد أنه أخبرهم في المستشفى بهُويتنا «الصحفية».. جاء الطبيب بنفسه للاطمئنان عليَّ.. حاول تلطيف الأجواء.. وجَّه حديثه إليَّ:
- الحمد لله إنت بقيت أحسن بكتير.. والعلاج جاب نتيجة، والضحكة كمان باينة على وشك.
- أبدًا.. الضحكة ملهاش علاقة بالتحسن..
- أومال إيه سر الابتسامة دي؟
- أنا متعود أواجه أي مرض بالسخرية منه.. أهزمه بالضحكة.. أتغلب عليه بالابتسام والتجاهل.. ولغاية دلوقت مفيش مرض قِدِرْ يهزمني.
- دا جميل.. الروح المعنوية، والحالة النفسية بتفرق كتير في مواجهة المرض.
لعدة ثوانٍ التزمتُ الصمت.. ثم تعمدت التغلب على الألم بالحديث مع زميلي «خالد»، ومع زوجتي.. وما أن انتهى المحلول حتى مددتُ يدي لأغلق بكرة الخرطوم البلاستيكي، دون انتظار الممرضة، أو حتى العاملة..
طلبتُ محلولًا آخر، ومسكنات أخرى.. كل شيء متاح طالما كنتَ قادرًا على دفع الثمن.. جاءت الممرضة ومعها المطلوب.. أفرغت ما في الحقن، والمسكنات في الكيس البلاستيكي المصلوب على الحامل الحديدي، كمتهم انتهى لتوه من تنفيذ حكم الإعدام شنقًا.
لم أنتبه هذه المرة إلى انتهاء السوائل.. ففوجئت بالدم يرتد عبر الخرطوم البلاستيكي.. فاستدعى زميلي إحدى الممرضات، التي تعاملت مع الأمر بـ«بلادة» منقطعة النظير.. فلم أشأ أن أدخل معها في نقاش أعرف مسبقًا أن الهزيمة ستكون من نصيبي.. واكتفيت بتوجيه حديثي لـ«خالد»: للأسف معرفتش أعاكسها!
ضحك خالد، وابتسمت زوجتي قائلة: قوم بس بالسلامة وابقى روح عاكسها براحتك..
في هذه الأثناء جاءت ممرضة أخرى وأعطتْ زوجتي ورقة بالحساب.. لحظات وعادت زوجتي قائلة: الحساب دا بتاع واحدة اسمها «إنجي» مش «أيمن».. ابتسمتُ قائلًا: إذا كان الأطباء بيخطأوا بحق المرضى، تبقى الحسابات مش هتغلط في الاسم؟
للمرة الثالثة حضر الطبيب العشريني، وطلب من الممرضة تصحيح الاسم إلى «أيمن» بدلًا من «إنجي»، والنوع من «أنثى» إلى «ذكر».. ثم عرض عليَّ إجراء عملية منظار، وبعض التحاليل في المستشفى..
تمسكتُ بالرفض.. فالمسكنات بدأت تؤتي أكلها.. والألم هدأ إلى حد ما، وبات بإمكاني العودة إلى القاهرة لمراجعة طبيبي أستاذ الجهاز الهضمي.. وقد كان.