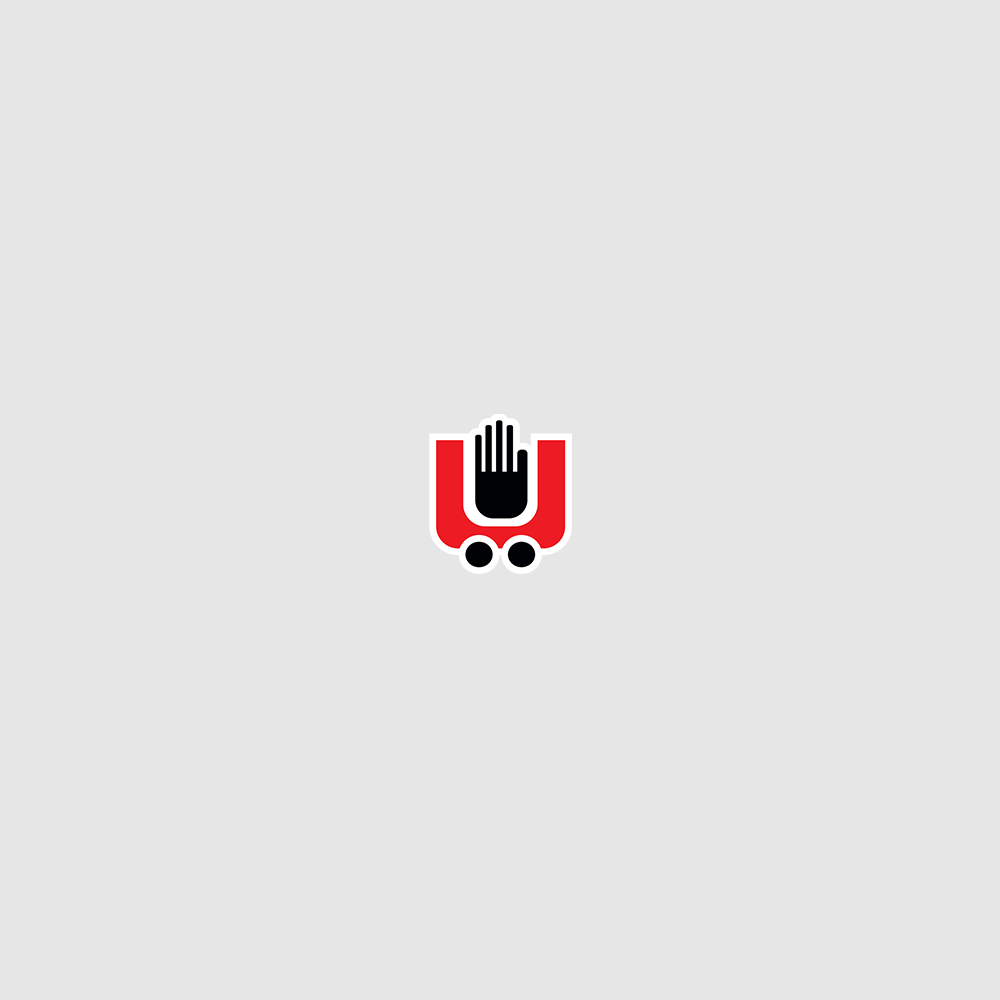الفتنة الطائفية.. مَنْ المستفيد؟!
منذ التاريخ السحيق لم يكن المصريون يعرفون التعصب، حتى لـ«الجنس».. تجلى ذلك في تولي الملكتين «حتشبسوت» و«نفرتيتي» الحكم، بينما كانت كثير من الدول والقبائل تنظر إلى «الأنثى» باعتبارها «نجاسة»، أو «عارًا» يجب التخلص منه.. «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ...».
لم يكن المصري عنصريًا، ولا عِرقيًا، ولا طائفيًا.. بل كان حضاريًا، سَمِحًا، «احتوائيًا».. يقبل الآخر.. ولا يجد غضاضة من أن يحكمه هذا «الآخر».. وربما يستدعيه للحكم، كما حدث مع الألباني «محمد على».
وليس هناك استشهاد أفضل من ما كتبه اللورد كرومر، المندوب السامي البريطاني على مصر عام 1906، في تقريره الذي رفعه إلى خارجية بلاده، وقال فيه: «في مصر لم أجد فرقًا بين المسلمين والمسيحيين سوى أن الأول يذهب إلى المسجد يوم الجمعة، والثاني يتوجه إلى الكنيسة يوم الأحد.. إنهم يعملون معًا، ويسكنون معًا في نفس الأحياء، ويتناولون نفس الطعام، ويتحدثون نفس اللهجة، ويضحكون على نفس النكتة...».
وتجلى هذا المشهد بوضوح في ثورة 1919، عندما خطب الشيخ في الكنيسة، والقسيس في الأزهر، ليردد الجميع: «عاش الهلال مع الصليب».. وقتها كان هذا الهتاف متغلغلًا في قلوبنا، وتترجمه أفعالنا.. ولم يكن مجرد شعارٍ تردده ألسنتنا، وتكذبه أفعالنا.. وقتها كنا محصنين ضد أمراض «الطائفية».. لم نحسبها يومًا حسبة «مسلم ومسيحي».. هكذا تربينا.. وهكذا تعلمنا في بيوتنا، وفي مدارسنا قبل أن تتحول إلى أشياء أخرى لا علاقة لها بـ«التربية» ولا بـ«التعليم».. فما الذي حدث؟ وما الذي غيَّر تركيبة الشخصية المصرية؟
لابد من التسليم بوجود مخططات إمبريالية للسيطرة على مقدرات شعوب العالم الثالث، من خلال استغلال نقاط ضعفهم، وعلى رأسها إذكاء نار «الصراع الطائفي»، وإحياء فكرة «الخلافة الإسلامية»، وتقسيم مصر إلى دولتين «قبطية» في الوجه القبلي، و«إسلامية» في بحري!
وفي كتابه «لعبة الأمم»، تحدث الضابط «مايلز كوبلاد» صراحة عن اجتماعات المخابرات الأمريكية، في أربعينيات القرن الماضي؛ لتحديد أفضل السبل لإحلال النفوذ الأمريكي محل البريطاني أو الفرنسي في الوطن العربي.
وللأسف، ما كانت مؤامرات الأعداء تحقق أهدافها دون أن تجد مَنْ يتبناها ويروج لها من العملاء وأصحاب المصلحة في الداخل، ابتداء من القصر أيام الملكية، وبعض كبار علماء الأزهر الذين احتفلوا بالملك فاروق «خليفةً للمسلمين».. بالإضافة إلى بعض القوى التي أججت الفتنة، كحزب الأحرار الدستوريين، وجماعة الإخوان المسلمين.
واستمرت «بيضة الفتنة» تنمو وتكبر، إلى أن ظهرت ثورة «النفط العربي»، وذهاب طوائف عديدة من المصريين للعمل في الدول العربية، خاصة الخليجية منها.. إذ بعدما كنا نُصدر العلم والثقافة، والأفكار، والمنهج الأزهري الوسطي لأشقائنا العرب.. أصبحنا نستورد من دول الخليج بعض عاداتهم وتقاليدهم القبلية، ومذهبهم «الوهابي» المتشدد.
أصبح كثيرون ينتشون لسماع خطب «الشيخ كشك» وهو يهاجم «النصارى»، ويسرد قصصًا «مؤثرة» عن إسلام أحد «القساوسة».. وبدأ بعضنا يبحث عن كتب وأشرطة «مناظرات» الشيخ «أحمد ديدات» لأحد رجال الدين المسيحي.. في مقابل ذلك رأينا مسيحيين «متطرفين»، أمثال «موريس صادق»، والقمص «زكريا بطرس»، وغيرهم من الذين يتطاولون على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم.. وينتهي المشهد بالتصفيق لأحد الطرفين، مثلما نصفق لفوز فريق على «عدوه اللدود»!
أما أخطر أسباب انتشار «الفتنة»
بهذا الشكل المخيف، هو تربية «الأمن» لبعض الدعاة «وارد الخليج»، والسماح لهم بالحديث
في «قشور الدين»، وإثارة القضايا الخلافية، وإطلاق الفتاوى «الشاذة»؛ لتغييب عقول الناس،
وإلهاء الشعب عن فشل «الحاكم»، وعدم التفات المواطنين إلى قمع وبطش الأجهزة
الأمنية، وانتشار الفساد في كافة المؤسسات الحكومية.. فأفسح لهم «الأمن» المنابر، والفضائيات؛
حتى خرجوا علينا بتحريم تهنئة المسيحيين، أو تحيتهم، أو البيع والشراء منهم، أو السكن
إلى جوارهم باعتبارهم «كفرة»، عليهم دفع الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، أو يجب قتالهم ليشهدوا
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله!
كل ذلك يتم بينما كانت الكنيسة شبه غائبة.. والأزهر فقد جزءًا كبيرًا من مصداقيته، عندما سمح لأي شخص بإعطاء دروس دينية، لمجرد أنه قرأ كتابين أو ثلاثة.. وعندما سمح لـ«شيوخ الفضائيات» بهذا الانتشار، حتى أصبحوا أكثر تأثيرًا من علماء الأزهر.. بدليل أن بعض المشكلات لم يستطع علماء الأزهر حلها، وربما تعرضوا للطرد أو الإهانة باعتبارهم «بتوع الحكومة»، بينما تم الترحيب بأمثال «محمد حسان».. تمامًا كما حدث يوم 5 مارس 2011، عندما أحرق متطرفون كنيسة الشهيدين بقرية صول بمركز أطفيح، بسبب «قصة حب» بين مسيحي ومسلمة!
وبدلًا من أن تواجه الدولة هذه الفتن بـ«قوة القانون»، لجأت إلى المسكنات، والحلول «العرفية»؛ ليتصدر المشهد صورة لقسٍ يحتضن شيخًا، أو حفل إفطار رمضاني لـ«الوحدة الوطنية»، إلى أن كانت الفاجعة الكبرى التي تعرضت لها السيدة «سعاد ثابت» صاحبة «أزمة الكرم».
ومَنْ يختصر الأزمة في مشكلة بين عائلتين، فهو غبي، جاهل، لا يدرك حقيقة الأمور.. فالأزمة ليست متعلقة بالشرف، وإن كان الشرف والعرض جزءًا منها.. لكن الأزمة أعمق وأخطر من ذلك بكثير.. الأزمة أزمة فكر.. أزمة ثقافة.. أزمة فهم حقيقي للدين.. أزمة موروث جديد يدمر هويتنا المصرية..
نعترف بأن إرث «التعصب الأعمى» ثقيل، وأن الأورام «الطائفية» أكبر من أن تُستأصل بين عشية وضحاها، بل تحتاج إلى علاج طويل الأمد، قد يستمر سنوات وعقود؛ لنتمكن من تخريج أجيال تؤمن بـ«المواطنة» و«التعددية»، وتستوعب ثقافة «الاختلاف».. المهم أن نبدأ.. نبدأ بإعادة النظر في الخطاب الديني.. نبدأ بـ«تطبيق القانون» على الجميع دون استثناء؛ بعيدًا عن كاميرات التصوير، وجلسات الصلح «العرفية»، بعيدًا عن الأحضان والقبلات والابتسامات التليفزيونية، ثم تعود ريما إلى عادتها القديمة!
الخلاصة: لا تحدثني عن «سماحة» دينك، لكن دعني أراها متجسدة في سلوكك وتصرفاتك!