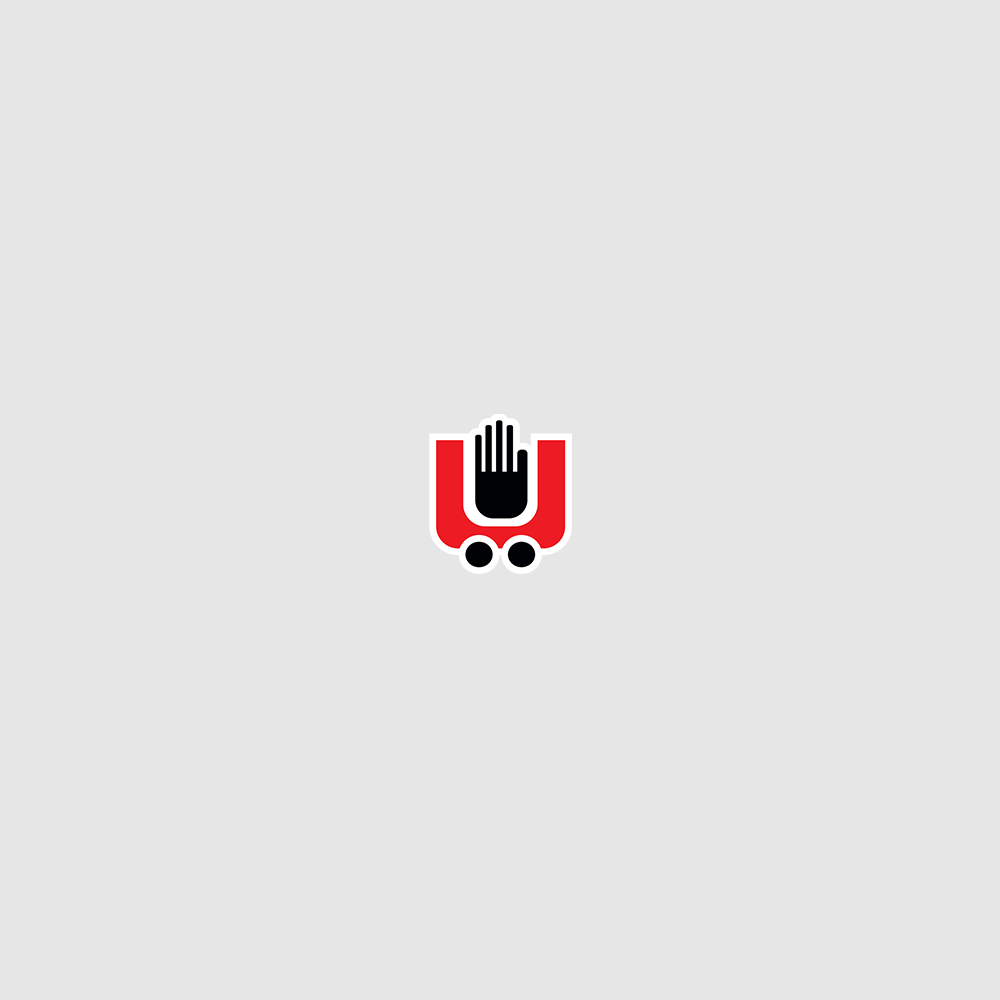تزييف التاريخ بالوراثة!
«لم نزوِّرْ التاريخ، ولكننا استجبنا لشكاوى التلاميذ وأولياء الأمور، والمدرسين». هكذا بررت وزارة التربية حذف اسم الدكتور محمد البرادعي من كتاب اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، ضمن الحاصلين على جائزة «نوبل»، وأن جميع المناهج التي تُدرس بالعام الحالي خضعت للمراجعة من خلال لجان تم تشكيلها بموافقة الوزير السابق محب الرافعي. وشددت على أن الأمر «ليس له أبعاد سياسية».
بشير حسن، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، قال إن الوزير الحالي الدكتور الهلالي الشربيني «شكل لجنة لفحص الأمر، وانتهت إلى أن عددا من المدرسين وأولياء الأمور تقدموا بشكاوى إلى الوزارة، يشيرون إلى أن الجزء المتعلق بالبرادعي في المنهج ليس في مستوى طالب المرحلة الابتدائية».
هنا يصبح العذر أقبح من الذنب، فمنذ متى والوزارة الموقرة «تسجيب لشكاوى التلاميذ وأولياء الأمور»؟ وإذا كان الجزء المتعلق بـ«البرادعي»- الحاصل على جائزة نوبل لـ«السلام» عام 2005- «ليس في مستوى تلاميذ الابتدائي»، فلماذا تركنا اسم العالم العالمي الدكتور «أحمد زويل»، وهو الحاصل على نوبل في «الفيمتوثانية»؟ أيهما أصعب على الفهم «السلام» أم «الفيمتوثانية»، أم أدب «نجيب محفوظ»؟
ثم أيًا كانت دوافع وملابسات حصول «البرادعي» على «نوبل» فلا يمكن تجاهله، خاصة وأنه أحد أربعة مصريين حصلوا على هذه الجائزة العالمية، التي سبقه إليها العالم أحمد زويل، والأديب نجيب محفوظ، والرئيس الراحل أنور السادات.
«آفتنا»- نحن البشر- أننا نجيد تزوير التاريخ لصالح الأنظمة الجديدة، فكلما حَكَمتْ أمة «لعنتْ أختها»، وشطبتْ تاريخها، ولوَّثتْ سمعتها، وشوَّهتْ إنجازاتها، وألصقتْ بها كل نقيصة.. في المقابل نستدعي كل آيات البطولة للنظام الجديد، ونتزلف إليه بكل معاني النفاق، ونُصوِّره- طواعية، ودون أن يطلب منا- على أنه «إله» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه..
«عاش الملك، مات الملك». نحن مَنْ اخترعنا هذه النظرية القميئة. وتاريخنا مليء بمثل هذه النماذج، ولكننا سنقفز إلى العصر الحديث؛ لندلل ببعض الوقائع.. فقد تطوعت أقلام للإشادة بـ«الثورة العرابية»، وبحكمة وحِنكة أحمد عرابي، ولم نخجل- بعدئذٍ- عندما وصفناها بـ«هوجة عرابي»، واتهمنا الرجل بالغباء والخيانة، وأنه كان السبب في احتلال بريطانيا للقاهرة.
وكنا ندرس في «مناهجنا» أن سعد زغلول «زعيم ثورة 1919»، وتغنينا ببطولاته، ونضاله ضد المحتل الإنجليزي، رفعناه إلى مرتبة القديسين.. فوجئنا بأقلام مؤرخين «من العيار الثقيل» تؤكد أن سعد زغلول كان «صديقًا للإنجليز»، وأنه كان «منحازًا للإسلاميين ضد الشيخ علي عبد الرازق- أحد كبار علماء الأزهر وقتذاك، وعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين»، رغم أنه كان «ليبراليًا»، والأخطر- كما قال روى في مذكراته- أنه كان «مدمنًا للقمار».
وكنا نتغنى بأمجاد الملك فاروق، ثم ما لبثنا أن انقلبنا عليه بعد «انقلاب، حركة، أو ثورة 1952»، واتهمناه بأنه، عربيد، سِكير، زير نساء، خائن، عميل... إلخ.
ولم يسلم أول رئيس للجمهورية، اللواء محمد نجيب، من هذا التشويه، بعد عزله، وتحديد إقامته، وأشدنا بالرئيس الجديد البكباشي جمال عبد الناصر، وتمسكنا به أكثر بعد «نكسة 5 يونيو 1967»، حينما خرج علينا معلنًا «تنحيه عن الرئاسة».
نفس اللعبة «القذرة» مارسناها مع الرئيس «المؤمن» أنور السادات، الذي أذهلنا ذكاؤه، وهللنا لانتصاره على الكيان الصهيوني في حرب أكتوبر 1973، ثم أهلنا عليه التراب بعد توقيعه معاهدة السلام مع المحتل الإسرائيلي في 19 نوفمبر 1977.
وما لبثنا أن اغتلنا إنجازات «السادات» بعد اغتياله في 6 أكتوبر 1981، وتولي نائبه حسني مبارك رئاسة البلاد، فمسحنا تاريخ الرئيس الراحل، وتطوعت بعض الأقلام لكتابة تاريخ يليق بالرئيس الجديد، فنسبت له الفضل في انتصارات أكتوبر المجيدة، وعكف شعراء «كبار» على كتابة أغنيات تتغنى بأصله الطيب، وبأمجاده وبطولاته الفذة، باعتباره صاحب «أول ضربة جوية فتحت باب الحرية».
وربما لم يشهد عهد من النفاق والتزلف إلى الحاكم مثلما شهدت السنوات الثلاثين لحكم مبارك، فتبارى الجميع- إلا مَنْ عصم ربك- في نفاقه، والتهليل لقراراته، والتسبيح بإنجازاته، وتقديم فروض الولاء والطاعة له بوصفه الراعي الأول لـ«الرياضة، والثقافة، والفنون، والعلوم، والأمن والأمان، وصاحب التوكيل الحصري للعيش، والحرية، والكرامة الإنسانية»!
وبعد الإطاحة بـ«مبارك» استبشرنا خيرًا، وتطلعنا إلى عهد جديد خالٍ من النفاق، وتأليه الحكام، وتزييف التاريخ.. لكن يبدو أننا غرسنا أشجارًا في الماء، وبنينا قصورًا على الرمال.. وسوف نتوقف طويلًا أمام ما حدث في العام الذي تولى فيه الرئيس الإخواني محمد مرسي حكم مصر.
ومؤخرًا انتقل «البوب»، الدكتور محمد البرادعي، من خانة «الأب الروحي لثورة 25 يناير 2011» إلى خانة الخيانة، والعمالة للغرب.. وأعتقد أنك إذا ما سألت أي حاكم عن رأيه في مثل هذه التصرفات الخرقاء، من قِبل بعض المسؤولين، يكاد لسان حاله يقول: ما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتهم فاستجابوا لي، فلا تلوموني ولوموهم.
ما سبق يدل على أن التاريخ لا يُكتب من خلال «الوقائع»، والتجرد من الأهواء، وعدم السعي لإرضاء الحاكم على حساب سابقه.. وإنما يُكتب بـ«المزاج»، وتتحكم فيه «الأهواء والأغراض الشخصية».. فإذا كان فلان «دمه خفيف» على قلب الحاكم وحاشيته، فيجب كتابته في التاريخ، ويستحق تدريس سيرته «العطرة» في المناهج.. أما إذا كان «دمه يلطش»، فلا يستحق مجرد ذكر اسمه، ولا حتى تدريسه في مناهج «كي جي ون»!