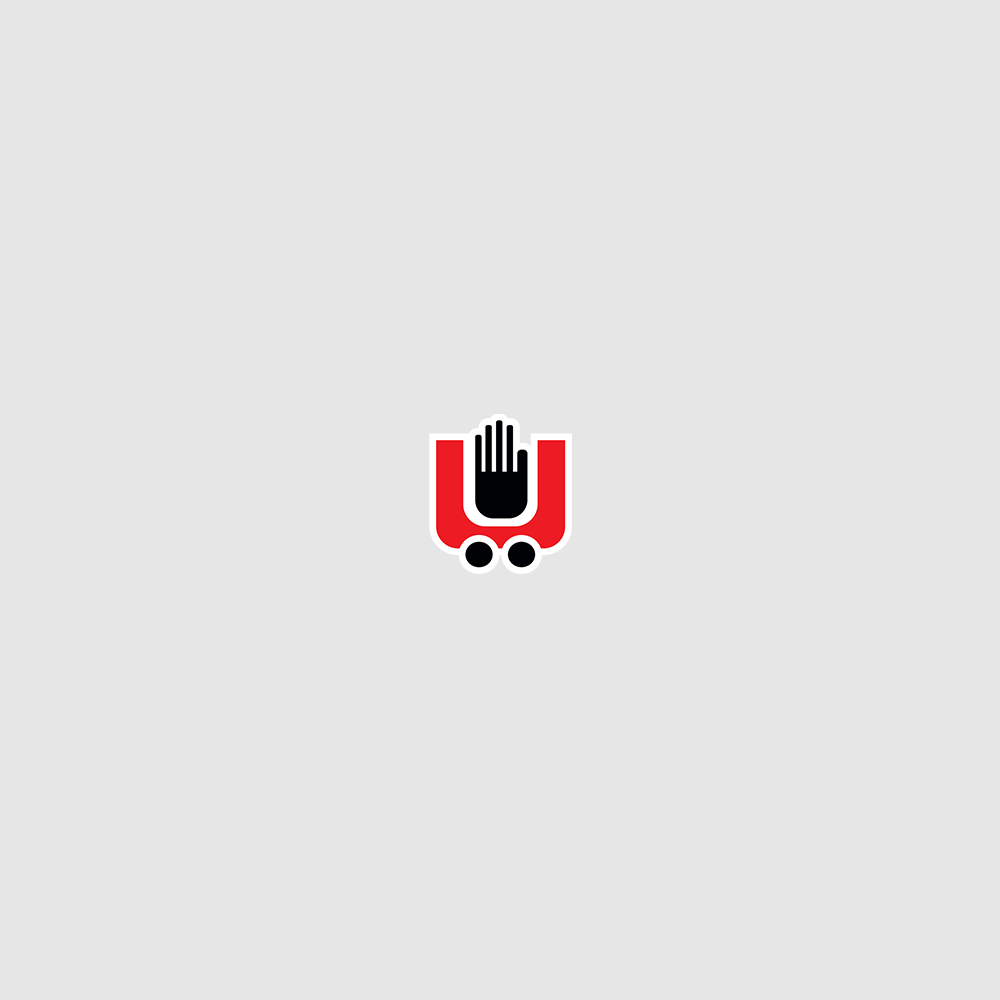جماعات المنتفعين
جرت عادتنا، نحن المصريين، على أن الرجل منا قد لا يعيره أحد انتباها أو التفاتا.. فإذا أصبح مسئولا، تغيرت النظرة إليه.. تبدو الحكمة والعبقرية والنبوغ في كل كلمة يقولها أو أي تصرف يصدر عنه.. فهو مفكر غير مسبوق، وله في الاستراتيجية والتكتيك، ويفهم في كل شيء.. هكذا فجأة، ودون مقدمات تذكر.
نحبه بلا حدود، ونعلن عن عشقنا له، ودفاعنا المستميت عنه على طول الخط، كأنه ملك طاهر نزل من السماء للتو، ليحتل مكانه بيننا على الأرض.. فهو لا يخطئ أبدا، والحق والصواب يعرفان به.. ما الذي حدث؟
إنها المداهنة والتملق والنفاق الذي يلازمنا، ويتبعنا كظلنا، في اليقظة والمنام، وفي الأحلام.. لا نتصور الحياة تمضي بدونه.. أين كنا يوم أن كان الرجل في الظل؟.. لقد كنا ساعتها مشغولين ومهتمين، بل كنا متيمين برجال آخرين ممن هبطت عليهم الزعامة والإلهام فجأة.. هل هي طبيعة شخصية فينا؟، أم أنها مهارات مكتسبة فرضتها علينا الظروف والأحداث؟.. أم هما معا؟!
أيام الصبا، كان بعض من زملائي في المدرسة يجيدون المداهنة والتملق لمدرسينا.. لا يجدون غضاضة فيما يفعلون، بل كانوا يعيبون علينا تقصيرنا وقلة حيلتنا وضعف قدراتنا ونقص إمكاناتنا.. هم الموهوبون، أما نحن فليس لنا في الموهبة نصيب.. كنا نستغرب ذلك، ونحاول أن نجد له تفسيرا، وكنا نتساءل: من الذي لقنهم وعلمهم هذا النهج الممقوت في هذه السن الباكرة؟.. كنا نحسبها فترة وتمضي، لكنهم بعد أن كبروا وصاروا رجالا، زادتهم الأيام والليالي من الخبرات والتجارب، ما جعلهم أكثر مداهنة وتملقا، بل تنوعت أساليبهم ووسائلهم بدرجة تثير الدهشة والذهول.
وينظر الإنسان ويتأمل ويتساءل: هل هذا معقول؟!.. بالطبع لا يخلو أي مجتمع من هذه النوعية، لكن المشكلة تصبح مخيفة إذا ما انتشرت وتفشت وصارت منهج حياة وأسلوب تعامل.. فإذا ما احتلت مكانة أو مسئولية أو قيادة، صارت الحياة غير محتملة.
في كل عصر سوف نجد جماعة من الناس يطلق عليهم "جماعة المنتفعين"، ملتفة حول الرئيس - أي رئيس - تماما كالتفاف السوار بالمعصم.. نراها حريصة في كل موقف - بل كل لحظة - على إثبات ولائها وإخلاصها له ولمنهجه، وأنها على استعداد لبذل النفس والنفيس في سبيل أن يظل على رأس المسئولية.. تعلن له في الصباح والمساء، أنها ليست طامحة أو طامعة في شيء، اللهم إلا رضاه عنها.. فنظرة الرضا منه تكفيها، بل تسعدها وتسكرها.
إن مهمتها أن تقول "آمين" لكل ما يصدر عنه، وأن تدافع عما يقوله، سواء كان حقا أو باطلا، صوابا أو خطأً، وأن تهاجم كل من يقف معترضا أو منتقدا أو غير راض عما يقال.. مثل هذه النوعية من الناس تمثل عقبة كأداء أمام أي تغيير أو إصلاح.. هي تعتقد أن الرئيس سوف يكون راضيا عنها سعيدا بها، فرحا بما تقدمه، وتنتظر ما يفيء به عليها كي تكون أكثر حماسا وبذلا وعطاءً.. لكن أصابع اليد الواحدة ليست متشابهة، وإذا كان التاريخ قد حفل برؤساء يعشقون المديح ويطربون له، ولا يستطيعون الاستمرار بدونه، وهو ما يؤدي في النهاية إلى فساد الأوضاع وانهيار منظومة القيم، فهناك أيضا رؤساء مستقيمون على الدرب، لا يتسق معهم هذا السلوك البغيض.. صحيح أنهم قلة قليلة، لكنهم موجودون.. غير أن جماعات المنتفعين لا تكل ولا تمل من الاقتراب منهم، ومحاولة التأثير فيهم، على أمل أن تنال حظها ونصيبها، وهذا بالطبع يفرض علينا - من أجل المصلحة العامة - أن نقرع أجراس التحذير والتنبيه والإنذار.
من الملاحظ في حياتنا أن المسئول إذا غادر موقعه لأي سبب كان، عاد مرة أخرى إلى حظيرة النسيان، فلا أحد يسأل عنه ولا أحد يهتم به.. والسبب هو أن مسئولا جديدا قد ظهر على المسرح، ويجب أن يلقى العناية الكافية والاهتمام المطلوب.
إن جماعة المنتفعين لا تريد أن تفوتها الفرصة.. تسعى بهمة ونشاط كي تحتل موقعها الدائم، وهكذا.. وغالبا ما تنظر هذه الجماعة إلى رئيس الدولة على أنه الدولة ذاتها.. ولم لا؟.. أليس هو رمزها والمتحدث باسمها؟.. ألم يقل لويس الرابع عشر: أنا الدولة؟.. يعني أنا الشعب والحكومة والوطن، كل ذلك مجتمعا.
ولأن الدولة هي التاريخ، والحاضر والمستقبل، والمجد والسؤدد، والملجأ والملاذ، ومحبتها في القلوب فريضة واجبة، والدفاع عن مكانتها وحريتها وعزتها شرف يسعى إليه الجميع، دون استثناء، فقد احتشدت جماعة المنتفعين خلف "الدولة"، رافعة شعارا مهما له بريقه، لتتميز به عن غيرها، ألا وهو "حب الدولة".. وهذا بالطبع لا يقلل من شأن الآخرين، فليس كل من رفع شعارا غيره هو كاره للدولة (!)