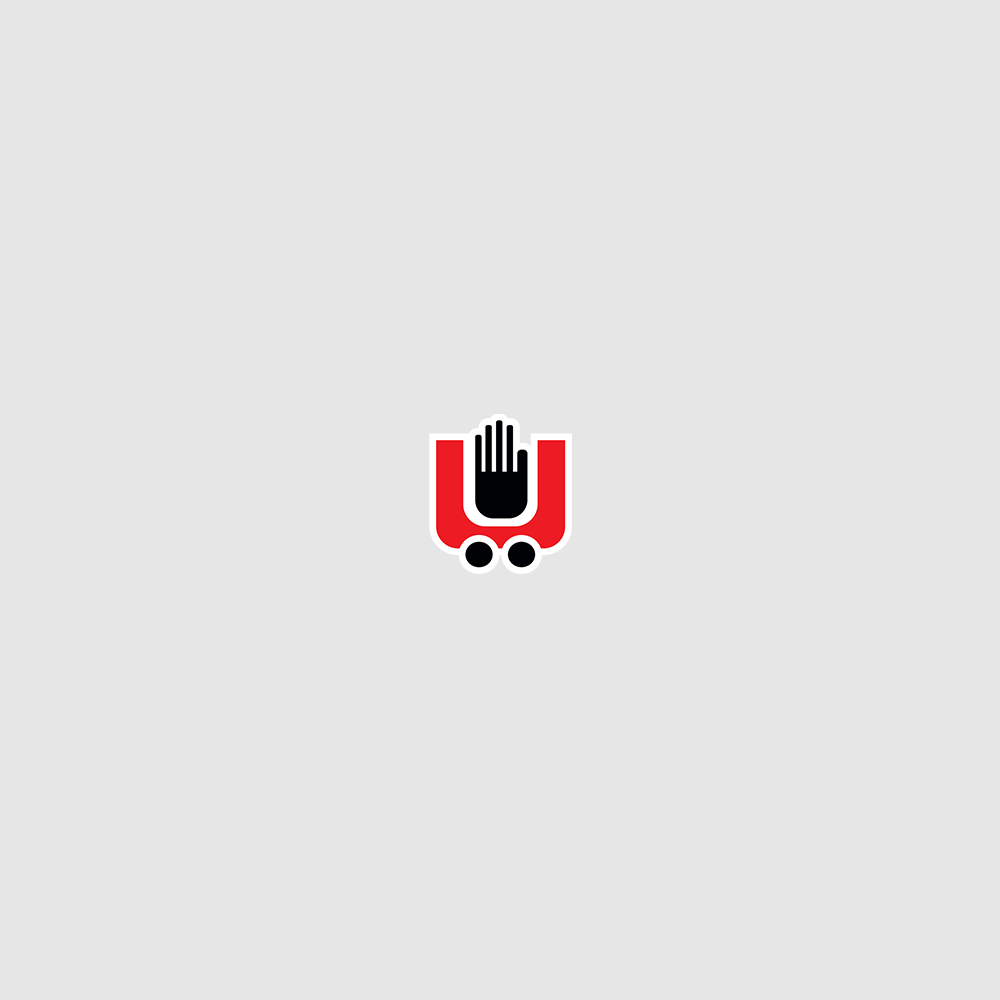ما بين يناير 2011 ويناير 2016
قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لثورة المصريين في 25 يناير 2011، وبالتزامن مع دعوات "متقطعة" من قوى محسوبة على المعسكر المناهض للنظام الحالي لثورة جديدة، تصبح المقارنة بين دوافع ومقدمات الثورة الأم من جهة والدعوات الحالية الخارجة على السياق من جهة ثانية أمرًا ضروريًا ولازمًا.
والضرورة هنا ليس "سببها" المصادرة على حق أي فصيل في الدعوة للتظاهر السلمي، بل الغضب من النظام –أي نظام- والدعوة لرحيله بالطرق السلمية والقانونية المشروعة، ولكن سببها هو ذلك الخلط المتعمد والمشوه بل المزيف بين أهداف وغايات فصيل أو فصائل أو تيارات أو حركات أو تجمعات محددة منخرطة في تلك الدعوة، وأهداف وغايات السواد الأعظم من الشعب المصري، الذي يملك وحده حق منح الشرعية أو حجبها، وسوابقه في 25 يناير 2011، ثم 30 يونيو 2013 شاهد على ذلك.
إن مقدمات ثورة 25 يناير 2011 كانت مختلفة بشكل جذري عن اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر، فقبل الثورة مباشرة كانت مسارات التغيير السياسي من خلال الانتخابات شبه مستحيلة، بسبب ممارسات التزوير المنهجي التي شهدتها كل الانتخابات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقد كانت انتخابات البرلمان في نهاية 2010 بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعدما مارس قادة الحزب الوطني وبعض أجهزة الدولة المتواطئة معهم التزوير وتزييف إرادة الناخبين على نطاق واسع، وأقصوا الأصوات المعارضة تمامًا عن المشهد السياسي، فيما بدا وكأنه تمهيد لتوريث السلطة لنجل الرئيس الأسبق من خلال برلمان معظم أعضائه موالٍ لم يأتوا بأصوات الناخبين، بل بتدخلات غير مشروعة للسلطة الحاكمة آنذاك.
من ناحية أخرى كان الفساد بجد منتشرًا ولا توجد إرادة سياسية حقيقية لمكافحته ولا حتى آليات لمواجهته.
أضف إلى ذلك مساوئ وعيوب دستور 1971 الذي كان حاكمًا آنذاك، والذي كان مقيدًا الحقوق والحريات العامة، وكان يجعل السلطة التنفيذية متغولة على سلطتي التشريع والقضاء، فضلا عن حالة الطوارئ التي فرضها نظام مبارك طوال فترة حكمه، وأغلق من خلالها المجال العام وصادر العمل المجتمعي ووضع الآلاف في المعتقلات دون محاكمة عادلة ودون أي اعتبار لقرارات جهاز النيابة العامة والأجهزة القضائية المعنية.
أما مساحة العمل الحزبي فقد كانت مغلقة بالضبة والمفتاح أمام أي تنظيم سياسي جاد، حيث حرم الملايين من حقهم في تكوين الأحزاب والانضمام إليها، ووضعت مسئولية إشهار الأحزاب وحلها في يد لجنة يديرها قادة الحزب الوطني، وبالتالي فقد منعوا وصول أي تنظيم حزبي جاد لمقاعد المنافسين، وحجبوا الشرعية عن أي مجموعة حاولت تكوين حزب رافض دور الكومبارس في المسرحية السياسية التي لعبها مبارك ونظامه على مدى 30 عامًا.
فهل من العدل والإنصاف مقارنة هذه المقدمات التي ما كان المصريون ليتخلصوا منها بغير الثورة، بحقائق المشهد الحالي المختلف جذريًا عما كان ؟
فالواقع الحالي يشهد بأن التغيير من خلال الانتخابات أصبح أمرا متاحا، وحتى مع وجود سلبيات طفيفة في العملية الانتخابية، فإنها أبدا لم تنتج عن تدخلات سلبية للسلطة، والدولة أثبتت حيادها التام والمطلق خلال ثلاثة استفتاءات دستورية، ومرتين لانتخاب رئيس الجمهورية ومرتين لانتخابات البرلمان، وبالتالي فالتغيير من خلال الصندوق أصبح مرهونًا بإرادة الناس وليس إرادة الحاكم.
كما أن محاربة الفساد أصبح لها مكانتها في الخطاب السياسي الرسمي للرئيس وحكومته، والأحداث التي شهدناها خلال العام ونصف العام الماضى خير دليل على ذلك، فالأجهزة الرقابية تتحدث عن وقائع الفساد بلا سقف ولا قيود، ولأول مرة في التاريخ المصري الحديث يتم تقديم وزير للمحاكمة بتهمة الفساد، وهناك استراتيجية وطنية معلنة لمكافحة الفساد، وبالتالي فالإرادة متوفرة لمحاربته حتى لو كانت وقائع الفساد ما زالت باقية وبارزة.
والدستور الذي نعيش في إطاره حاليًا يصون الحقوق والحريات، ويعبر بشكل واضح عن تطلعات وآمال وأحلام المصريين، وحالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية ولت بلا رجعة، ولم تلجأ إليها السلطة رغم ما تواجهه من إرهاب منظم وغير تقليدي.
وأما تكوين الأحزاب فقد أصبح بالإخطار، ولدينا على الساحة حاليا ما يزيد على 100 حزب سياسي منها 44 شاركت في آخر انتخابات برلمانية، ومعظمها يعمل بحرية مطلقة في الشارع دون أي قيود.
في ضوء هذه المقارنة العادلة والموضوعية تفتقد الدعوة ثورة جديدة مبرراتها المنطقية، وتصبح جزءًا من عملية فوضى يريدها أصحاب الدعوة شاملة وعامة، لكن دعاة الفوضى تناسوا أن الشارع أكثر إدراكًا وذكاءً منهم، ورده على دعوتهم في 25 يناير 2016 سيكون خير دليل على ذلك.