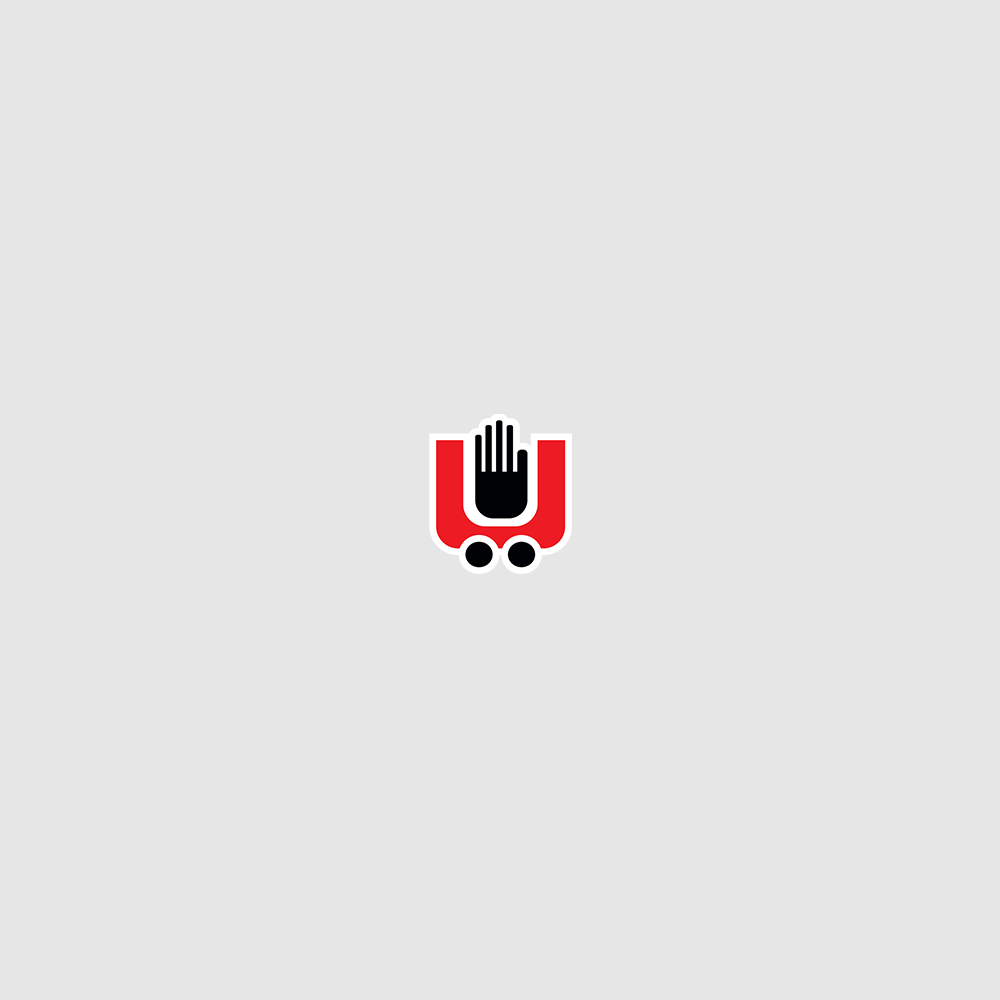ويسألونك عن «المِأسفنين»!
خبرٌ.. مجرد خبر لـ«مصورة فيديو» بصحيفة خاصة، اتهمت زميلها المصور بجريدة خاصة أيضًا، بأنه ينتمي لجماعة «الإخوان»، وبسرعة، ألقى «الأمن» القبض على الزميل أثناء تغطيته إحدى جلسات قضية «التخابر مع قطر»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون.. وتم التحقيق مع الزميل، وإحالته إلى النيابة، التي قررت الإفراج عنه بكفالة.
انتهى الخبر بتفاصيله العريضة، وما خفي كان أعظم..
وبعيدًا عن صدق الرواية من عدمها.. هل آلمك ما حدث لزميلنا المصور أحمد رمضان؟ هل بكيت على ما آلت إليه الجماعة الصحفية، وسلوك كثير من أبناء صاحبة الجلالة؟ هل استحقرت ما حدث معه؟
الإجابة النموذجية المثالية الأفلاطونية: نعم تألمتُ، وبكيتُ، واستحقرتُ.
لكن، وعيني في عينك كده، كم مرة تمنيتَ أن تفعل في زميلك ما فعلته أماني الأخرس في زميلها أحمد رمضان؟ كم مرة تمنيتَ أن تتقرب من «الجهات الأمنية»؛ لترهب زملاءك، أو، على الأقل، تخويفهم وابتزازهم؟ كم مرة أبديت استعدادك لتقديم خدماتك المجانية لعسكري أو أمين شرطة اسم الله؟
ثم دعك من كل هذا وذاك.. أنت، وإياك أن تكذب، كم مرة تسببت في قطع عيش زملائك؟ كم مرة «أسفنتهم» عند رئيسك المباشر وغير المباشر؟ كم مرة «خزوقتهم» بدعوى «قلبك ع الشغل»، ومصلحة العمل؟ كم مرة تبسمتَ في وجه زميلك ثم طعنته في ظهره؟
كان من الممكن أن تمر «الفضيحة» مرور الكرام، كما مرت حوادث أخرى لا نعلمها، لولا أن الأمور تطورت إلى الأسوأ، عندما أكدت «الداخلية» و«النيابة» أن الزميلة هي التي أبلغت عن زميلها، و«وشت به»، وأبلغت عنه أنه «إخواني».
«الأسفنة» هي المرادف لمصطلح «الخازوق» بعد إجرائه عملية تجميلية، وهي «فن عظيم لا يتقنه إلا المنافقون»، وقد عرفتُ معناها، لأول مرة في حياتي، أوائل تسعينات القرن الماضي، عندما التحقتُ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.. وخلال سنوات الدراسة صادفتُ نماذج عديدة من «المِأسفنين»، و«المرشدين الأمنيين»!
وبعد التخرج، وممارسة حياتي المهنية، عرفت أن أهم موظف في أية مؤسسة هو «العصفورة»، الاسم الحركي لـ«المِأسفن»، الذي يقوم بدور «كاميرات المراقبة»؛ لنقل كل كبيرة وصغيرة عن زملائه، وهذا الشخص يتم اختياره وفقًا لمهارات خاصة، تختلف من «مِأسفن» إلى آخر، ومن مؤسسة إلى أخرى.
و«المِأسفنون» نوعان: أحدهما يُعرض خدماته طواعية؛ استجابة لـ«جيناته الوراثية»، وميوله التطلعية، وأحلامه الكارثية.. والآخر يصنعه المدير «البِرّاوي» على عينه، يربيه في كنفه، ويسبغ عليه من عطاياه، ويحرص على عدم كشف هويته؛ كنوع من أنواع السيطرة على الموظفين، والضغط عليهم وقت الحاجة.
بمرور الوقت يُصبح «المِأسفن» معروفًا، ويُصبح منبوذًا من الجميع، إلا البعض يحاول التقرب إليه، يلاطفه، ويخطب ودَّه؛ اتقاءً لشرِّه، أو للمحافظة على «لقمة عيشه» ومستقبله الوظيفي، أو ربما طمعًا في ضمه إلى «زمرة العصافير»!
و«الوشاية» أو «الأسفنة» أو «المهموز» لم تتوقف عند الموظفين فقط، بل إن أحاديث معلنة تشير إلى تورط أدباء، ومفكرين، وإعلاميين، وسياسيين كبار، تورطوا في هذه الفضيحة الأخلاقية، وكلٌ حسب استعداده وقدراته.. كما تورطت دولٌ في دق «أسافين» بين البلاد وبعضها، وكانت سببًا في احتلال الأراضي، وسفك دماء الأبرياء.
نكتة
يُروى أن أحد المديرين «الغِلْسِين» قال نكتة لموظفيه، ففطسوا من الضحك ما عدا شخص واحد.. فقال له المدير: انت مبتضحكش ليه؟ فقال له: أنا مش مضطر أعمل زيهم، عشان أنا خلاص هسيب الشغل بكرة!